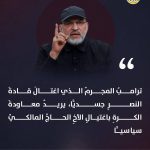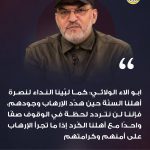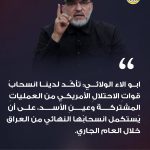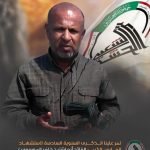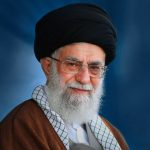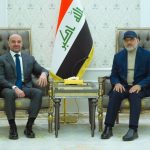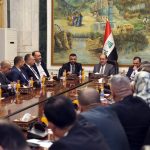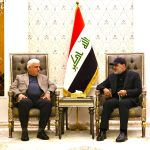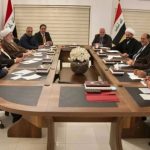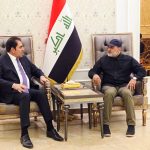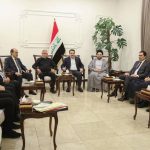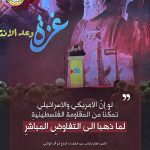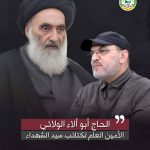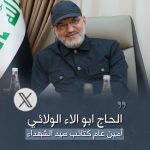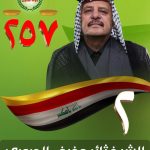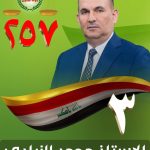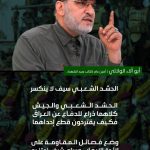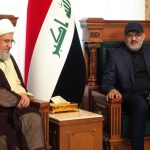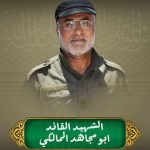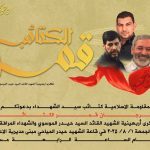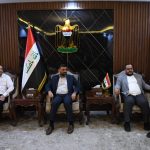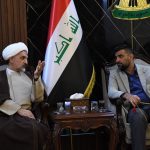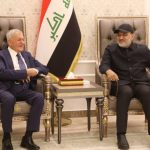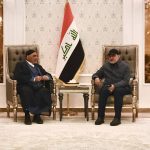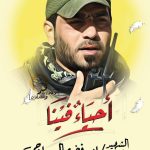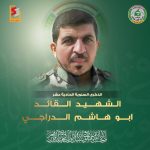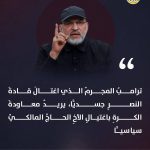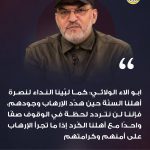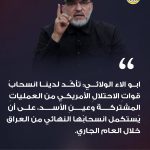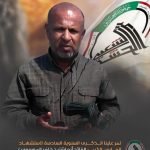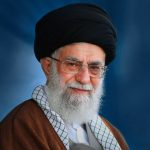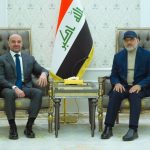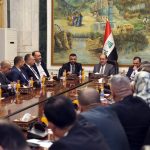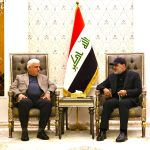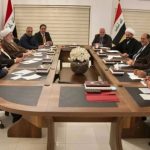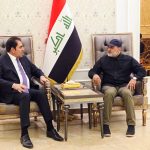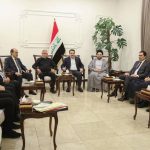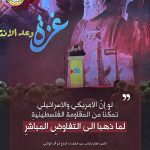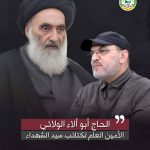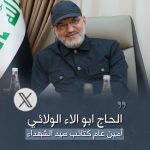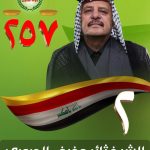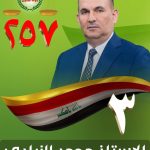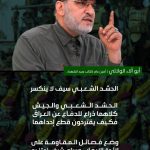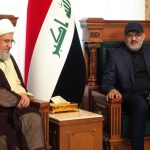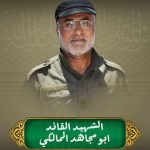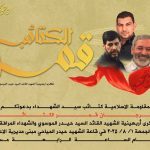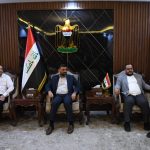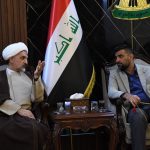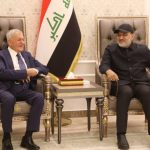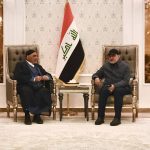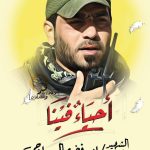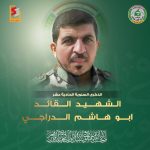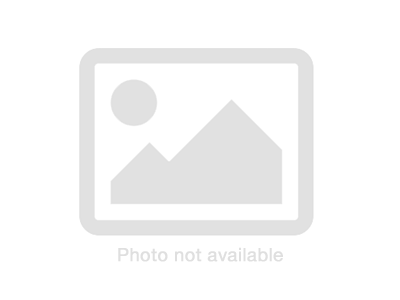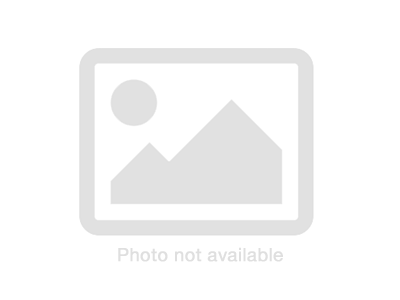الثقافة مصطلح عام وعنوان يشتمل على مفردات واسعة، وينطوي على تنوع كبير حتى في حال انتساب الثقافة للإسلام.
الإمام يحدد سمات الثقافة الإسلامية المنشودة في النهضة، ويعطي الهدف والقيمة لها من خلال قدرتها على تربية الإنسان وتزكيته، ولو بقيت الثقافة كعنوان عام بدون قيود وضوابط ومحددات تصير أداة هدم أو لا تؤدي غرضها على الأقل.
يقول سماحته في هذا المضمار: «العالم الذي لا يقترن علمه بتهذيب الأخلاق والتربية الروحية، فإن علمه يستوجب ضرراً للشعب والوطن يأتي أكثر من ضرر الذين لا يعلمون» . وفي نص آخر لا يعبأ الإمام بالقيمة المعرفية لأشرف العلوم، إذا انسلخت عن هدفها الإلهي وانفصلت عن قاعدتها الأخلاقية، حيث يقول: «التعليم والتعلم، الفقه والفلسفة، وعلم التوحيد، ما دامت لا تكون باسم الله فإنها لا تنفع» .
إذا كان البعض لا يفقه هذه المعاني أو يستغربها وينسبها للتطرّف والمثالية، فإن ما يجب أن ننتبه إليه أن حركة الإمام وأفكاره في النهضة هي جزء من حركة الإحياء الديني، وبالتالي هي حركة تنفتح على الغيب أولاً وتستمدّ منه قبل كل شيء؛ وهي في هذا المعنى تلتقي مع الأساس المتين لعقيدة المسلم الذي لا يصحّ منه إسلامه دون هذا الانفتاح العميق على الغيب والاستمداد منه.
وهذا هو جوهر الحركة الإحيائية للإمام وأصل خطابها النهضوي سواء أكان ثقافياً أو غير ثقافي.
7- الشعب أم المؤسسة؟
مَن الذي يُبرز حركية التعبئة في بلاد المسلمين الشعب أم المؤسسة؟ تكشف قراءة التجربة الخمينية في إيران واستلهام منطلقاتها النظرية أن الإمام رفض إخضاع المسألة إلى خيارين هما الشعب أو المؤسسة، فالأصل هو الإنسان و الشعب، والمؤسسة العسكرية، أو الجهادية أو التعبوية هي مجرد إطار أو وسيلة تمليها الحاجة إلى إدارة فعل المقاومة أو المواجهة أو الدفاع.
بناءً على أصالة الأصل شهدت التجربة الإيرانية ثلاث صيغ مؤسسية للقوة العسكرية هي الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية، من دون أن يكون أي واحد منها بديلاً للأصل المتمثل بالشعب نفسه، ولا ينبغي أن يحصل ذلك، وإلا فهي الكارثة ونهاية التجربة ذاتها!
على هذا نعتقد أن سؤال: هل تومئ التعبئة في فكر الإمام إلى فئة عسكرية ومؤسسة خاصة أم أنها تمثل مفهوماً عاماً يطوي خللاً منهجياً؟ ففكر الإمام يتناول بالدرجة الأولى والأخيرة حالة الشعب بشكل عام، وإذا أراد أن يتخصص بفئة، فإن ذلك يعود إلى ارتباط هذه الفئة بالبنية الاجتماعية العامة. بمعنى أن الإمام عندما يتحدث عن الجامعة كمفهوم أو ظاهرة، وعن المثقفين كفئة، فلا يقصد التعامل الميكانيكي مع هذه الظواهر بوصفها وجودات مستقلة قائمة بذاتها، الواحدة فيها بمعزل عن الأخرى، بل ينظر إليها سماحته كبنى مترابطة تدخل بشكل متواصل في تكوين النسيج الاجتماعي العام أو ما نطلق عليها حالة الشعب.
وفي غير هذا الاتجاه من النظر سيقع دارس نهضة الإمام الخمينيّ في خلل منهجي خطير تسقط معه أول ما تسقط القيمة التغييرية في فكر الإمام. فالإمام قبل كل شيء هو داعية الإسلام الذي يعنيه أن يدخل حالة الشعب -وحال الأمة في مستوى آخر- بمفهومها العام والشامل ليقطع صلتها مع كل ما هو غير إسلامي، ويعيد صلتها بالإسلام.
قضية التعبئة لا تخرج عن هذا الفهم، فمقتضى القيمة التغييرية لفكر الإمام تفرض أن يدخل سماحته المفهوم (التعبئة) في الحالة الاجتماعية العامة ليخلص إلى بناء حالة عسكرية متخصصة.
لا ريب أن الترابط القائم بين الاثنين واضح بينهما، فليس بمقدور الأمة الراكدة المخدرة أن تنتج حالة جهادية تعبوية عسكرية فاعلة، ،خاصة كالحالة الواسعة التي شهدتها الثورة الإسلامية. فعملية توجّه مئات الآلاف من المقاتلين من كافة الفئات الاجتماعية إلى جبهات القتال وحضورهم الفاعل/ الرادع طوال سنوات الحرب الثماني، لم يكن أمراً ممكناً لو لا أن الشعب ذاته خضع بدرجة وأخرى إلى حركية مفهوم التعبئة وتفاعل مع القيم الجهادية لهذا المفهوم.
ما ينبغي الإشارة إليه في نهاية هذا التوضيح أن من دأب الإمام ودأب منهجه التغييري أن يتوجه نحو الأمور الكلية العامة فيكسر بناءاتها القديمة ويعيد تشييدها مرة أخرى على أساس الإسلام ووفق مفاهيمه وأحكامه.
إذن، بدأت التعبئة حالة اجتماعية/شعبية عامة قبل أن تتخصص بقوات التعبئة المعروفة في إيران بـ(البسيج) ومؤسستهم. بل لم يكن لظاهرة (البسيج = التعبئة) أن تولد وتنمو بالسعة والعمق اللذين شاهدناهما بها، خلال سنوات الحرب الثماني من دون أن يكون خلفها وفي قاعدتها التحتية أمة معبأة مستعدة للتضحية والعطاء.
نصوص الإمام الراحل وفيرة وواضحة في هذا الاتجاه، ففي حديثه مع ضيوف الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصار، قال سماحته معبراً عن الروح الشاملة لمفهوم التعبئة: «قبل الثورة الجبارة والقاصمة التي وقعت في إيران، وقعت في داخل الجماهير ثورة تمثلت في توجه جميع الشعب نحو الإسلام الذي كان إلى هذا العصر، وخصوصاً في القرون الأخيرة، في طيّ النسيان، ولم يبق منه سوى طقوس جامدة لا أثر لها على أحوال الشعوب» .
يطالعنا هذا النص بعد إثباته التعبئة كمفهوم عام يعم الشعب جميعاً، بأن مضمون التعبئة يقوم على الإسلام دون غيره، وأنَّّّ قيمة التعبئة الأساسية تكمن في الفداء والتضحية.
بعد هذه الإشارة الوجيزة نعود مرة أخرى إلى الإمام، وهو يعرض لحالة التعبئة العامة التي اجتاحت الشعب على أساس الإسلام، فيقول: «وهذا الشعب بمشيئة الله تبارك وتعالى وألطافه الخاصة انقلب في البداية في الجوانب المعنوية، الشباب عاد عن حاله السابق إلى الإسلام، وعرف كيف ينبغي أن يكون، وماذا يعمل، وإثرها جاءت هذه الثورة، ولولا ذاك التغيير الداخلي لما اختلف حال هذه الثورة عن باقي الثورات، فالثورة الداخلية لهذا الشعب وتعرّفه على الإسلام وتوجهه نحو الله تعالى، هذه الأمور مجتمعة هي التي أثمرت هذه الثورة، وهي التي حفظتها وأوصلتها إلى الانتصار، وأسفرت عن تعاظم حضور هذه الجماهير والتزامها، وهذه الثورة الداخلية هي أيضاً ما كانت لتكون في هذا البلد إلا بألطاف الله تبارك وتعالى.. فلنبحث عن الانتصار في ثورة أعماق الجماهير» .
يتضح من هذا النص أن التعبئة حالة جهادية حركية عامة سادت الشعب وعملت على نقله من الركود إلى الحركة، ومن الأنانية إلى التضحية والعطاء. وحركية التعبئة وروحها العامة ومضمونها قائم على أساس الإسلام، والتعبئة سبقت الثورة ومهدت لها فأنتجتها بوصفها أرضاً لانتصارها، وهي بعد ذلك ضمانة لديمومتها وحفظها وتحصينها ضد التحديات الخارجية والمنزلقات الداخلية.
وهذا ما يضعنا أمام أصل آخر من أصول النهضة يتمثل بإشراك الشعب في المواجهة والاستمداد من طاقاته الجبارة، وعدم قصر المقاومة على الأطر المؤسسية حتى لو كانت في أعلى درجات الكفاءة والتخصص.
8 – تفعيل قانون القلة
من الأصول الأخرى التي أعادت الروح التعبوية تشييدها في الأمة وتفعيلها فيها، من خلال منهج الإمام الجهادي، هي إعادة دور القلة المؤمنة في بحر الضلال والانحراف. فخطورة التصحيح والتغيير ومستقبلهما تكمن في الخطوة الأولى التي غالباً -بل دائماً- ما تكون من نصيب قلّة قليلة تقود حركتها إلى تجميع القوى الخائفة والمترددة والراكدة من ورائها. وبدون القلة، التي تكسر حواجز الخوف وتنزع الهيبة الراكزة في نفوس الكثرة وتبني الأفكار، فإن عملية التغيير يقضى عليها أن تبقى تمنيات حالمة ونظريات في مطاوي الكتب، وبحسب تعبير الإمام: «الأفكار تبدأ صغيرة، ثمَّ تكبُر، ثمَّ يتجمع حولها الناس، ثمَّ تكتسب القوة، ثمَّ تأخذ بيدها زمام الأمور» [22]. هذه قاعدة مطّردة هي أقرب ما تكون إلى السنّة الشاملة التي لا تستثني أحداً: «ففي كل العالم على مرّ العصور كانت الأفكار تتفاعل عند مجموعة من الأشخاص، ثمَّ يكون تصميم وتخطيط، ثمَّ بدء العمل ومحاولة نشر هذه الأفكار وبثّها من أجل إقناع الآخرين تدريجياً» [23] والمبادرة هي أبداً بيد قلة تزرع الأمل بإمكان التغيير وتمسك بيدها زمام المبادرة.
وفي إشعاع نور صاعد يستلهم الإمام أفق العمليات التغييرية الكبرى على مسرح تاريخ النبوات وتاريخ الإسلام، فيسجل في نغم يوصل بين الحاضر والماضي: «السلام على إبراهيم خليل الله الذي هاجم الأصنام وعبّادها وحده، ولم تخفه الوحدة أو ترعبه النار، والسلام على موسى الذي رفع عصاه في وجه الفراعنة ولم يخش أحداً، والسلام والتحيات على محمد حبيب الله الذي انتفض وحده وحارب الكفار الظالمين حتى آخر ساعات حياته، ولم يشك من قلّة العدد والعدة، والسلام على مسلمي صدر الإسلام الذين هاجموا سلاطين الروم وإيران الجائرين بقليل من الإمكانيات ولم يسمحوا للخوف أن يتغلغل لقلة الناصر. والسلام الخالد على علي بن أبي طالب الذي حارب الجلادين المتلبسين بلباس الإسلام والقداسة دون أن يخشى قوةً ما، والسلام على الحسين بن علي الذي ثار بأنصاره المعدودين للقضاء على ظلم الغاصبين للخلافة ولم يفكر بمساومة الظالم على الرغم من ضآلة العدد والعدة» .
بعد مقاطع أخرى يوصل الإمام الحاضر بالماضي، ويؤسس لحركة الأمة التعبوية الجهادية الحاضرة بالتواصل مع جذورها العميقة في أنموذج النبوات وأصول الإسلام، فيصحح ما كان مقطوعاً في الأذهان والنفوس وفي واقع المسلمين، فيقول: «إن أصحاب الدنيا يعتبرون ما صدر من أولياء الله العظام هؤلاء، مخالفاً للعقل والشرع، فعقلهم يرفض الثورة بالعدة القليلة وشرعهم لا يسمح بذلك» .
أما نهج الإمام في التحريك والنهضة، فقد أعاد هذا القانون إلى حيز الفاعلية والحضور.
أهمية هذا القانون أنه يلغي تلك الأحكام المتسرعة العجلى التي بادرت وتبادر إلى إلغاء الفاعليات الحركية والحزبية والتجمعات النخبوية. فكل هذه الوجودات تتحول إلى ضرورة لا مناص عنها لإطلاق شرارة الحركة في الشعوب وتفجير طاقاتها المخزونة، بشرط أن تعي دورها هذا ولا تتخلى عنه، والأدهى أن لا تتحول أداة لتجميد الأمة والحؤول دون انطلاقها أو إلى وجودات بديلة للشعوب ذاتها، كما حصل ذلك لبعضها فعلاً، فقاد إلى أحكام متسرعة وعجلى بضرورة التخلي عن هذه الكيانات بالكلية.
تفتح هذه النقطة أفقاً واسعاً لمعالجة الوجودات الحركية والحزبية الإسلامية في بلاد المسلمين، من زاوية الإثارة التي بين أيدينا أو من زوايا أخرى، وهو ما يستدعي بحثاً مستأنفاً ليس هذا محله.
9 -عنصر التضحية
تقوم فكرة التضحية والفداء والاستشهاد في الدين الإسلامي على مرتكز اعتقادي يؤمن بفناء هذه الحياة الدنيا والخلود في الحياة الأخرى، لذلك تُهدُّ الشهادة – وهي من مراحل الفداء المتقدمة – فوزاً، وفي ذلك يحدثنا الإمام بعد استشهاد المفكر مرتضى مطهري في 2/5/1979، بقوله: «إن أحد دروس العقيدة الإسلامية ومدرسة التوحيد هو أن رجال هذه المدرسة يعتبرون الشهادة فوزاً عظيماً لهم (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً)» .
ثم يتقدم الإمام خطوة إلى الأمام، وهو معلم الأخلاق العظيم، وفاتح دروب الشهادة والفداء أمام قوافل الشهداء في عصرنا الإسلامي الحاضر، فيقول إنهم «يستقبلون الشهادة لأنهم يعتقدون بأن وراء هذا العالم المادي عوالم أسمى وأنور من هذا العالم. هذا العالم سجن المؤمن، وبعد الاستشهاد يخرج المؤمن من السجن، هذا هو أحد الفروق بين مدرستنا، مدرسة التوحيد، وبقية المدارس الأخرى، فشبابنا يتمنون الشهادة وعلماؤنا الأعزاء يتسابقون إلى الشهادة» .
ثم ينقل الإمام هذه القيمة الاعتقادية إلى حيزها العملي في تجربة الدولة الإسلامية، ويطلق إرادة التحدي فيقول: «الذين لا يعتقدون بالله ولا باليوم الآخر يجب أن يهابوا الموت، يجب أن يخافوا من الشهادة. نحن تلاميذ مدرسة التوحيد لا نهاب الشهادة، فليجربونا كما جربوا بالفعل» .
كلما تحين فرصة للحديث عن الثورة الإسلامية في خصائصها ومزاياها نرى الإمام يحرص على تبيان خصوصية دوافعها مقارنة بغيرها من الثورات والانقلابات السياسية، ففي الذكرى الثامنة للانتصار، وبعدما تحدث عن الثورتين الفرنسية والروسية وأبان دوافعهما المادية، انتقل سماحته إلى الثورة الإسلامية فقال: «فالثورة التي قمنا بها وقام بها شعبنا، كانت منذ اليوم الأول، ومنذ الهتاف الأول فيها، من أجل الإسلام، لا من أجل الوطن ولا من أجل الشعب ولا من أجل السلطة، بل جاءت من أجل إنقاذ الإسلام من شر القوى الكبرى والمجرمين الأجانب… هذا الدافع الإسلامي ملحوظ بوضوح عند شبابنا وعند عامة الناس إلا ما شذّ وندر، فعند ملاحظة هذا التسابق نحو الشهادة بكل شوق لدى عامة الناس في هذه النهضة، وعندما نسألهم وهم متوجهون إلى الجبهات وكلهم شوق وحماس: لماذا تذهبون إلى الجبهة؟ يجيب كل واحد منهم: نذهب من أجل الإسلام وفي سبيل الله. ولكن إذا وجهنا هذا السؤال إلى جندي روسي مثلاً، فسيجيب: أقاتل من أجل السيطرة على هذا البلد، أو من أجل أن أبسط نفوذي» .
تتجسد القيم والدوافع في الفهم الإسلامي من خلال المواقف والأعمال، وأفضلها ما يكتسب القدرة على التغيير العام، كما حصل في إيران حينما تجلّت القيمة التغييرية للتضحية في إنهاء عهد الطاغوت وانتصار الثورة الإسلامية. وبعد النصر عملت الروح ذاتها في فعلها التغييري والحركي على إدامة النصر ودفع المخاطر ومواجهة التحديات، بدءاً من مشكلات الداخل وانتهاء بالأشكال الإقليمية والدولية التي اكتسبت فيها عدوانية السنوات الثماني موقعاً كبيراً ومتميزاً.
هذه العلائق والجدل المحكم القائم بين هذه الأصول يعبر عنه الإمام الراحل في حديث له في الذكرى الثامنة للانتصار، فيقول: «إن شباب إيران إنما يتوجهون إلى الجبهات طالبين الشهادة، لأنهم يرون الشهادة فوزاً عظيماً، وإن اعتبارهم الشهادة فوزاً عظيماً ليس لأنهم يموتون وينالون الشهادة قتلاً، إذ إن الطرف الآخر يُقتلون أيضاً، ولكن المقصود هو الدافع الإسلامي لديهم، فعندما يكون القتل من أجل الإسلام عند ذلك يشعر الإنسان باللذة لا بالحزن» .
في المناسبة ذاتها أضاف الإمام لضيوفه موضحاً: «أنتم تشاهدون أن إيران تتعرض كل يوم للقصف ويسقط الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين قتلى، تتهدم البيوت على رؤوسهم، لكن بالرغم من ذلك تراهم عندما يخرجون من تحت الأنقاض يهتفون بوجوب استمرار الحرب حتى النصر» . تحديات قاسية مثل هذه يرافقها ضغوطات اقتصادية وخلل كبير في الخدمات كالماء والكهرباء والهاتف، من الممكن أن تدفع الشعب نحو النكوص والتقهقر لولا رصيده من انتمائه العقيدي وهويته الدينية والدافع الإسلامي للحركة.
شارك المقال