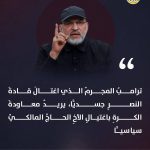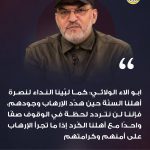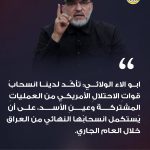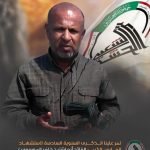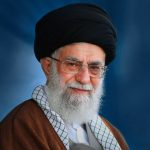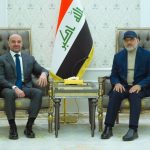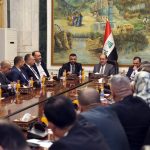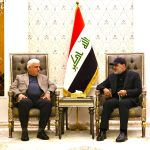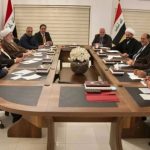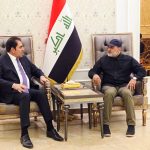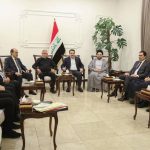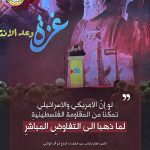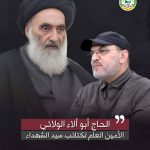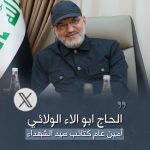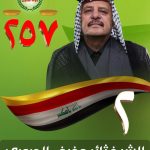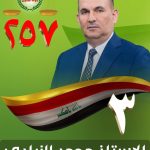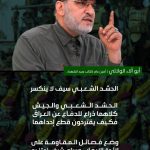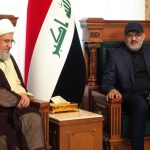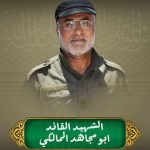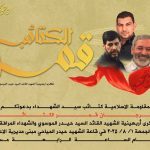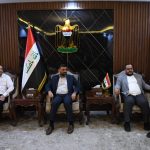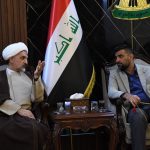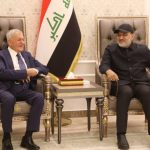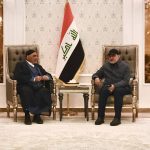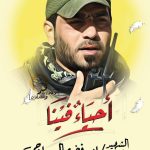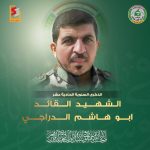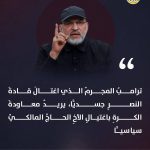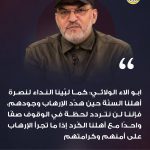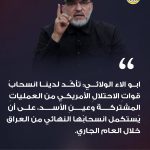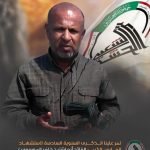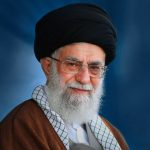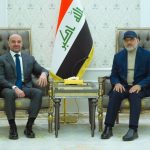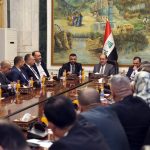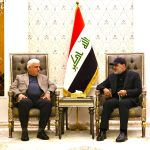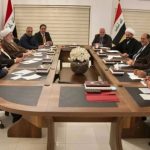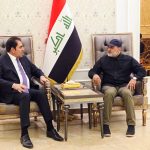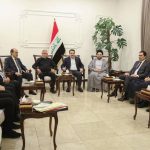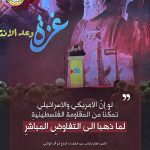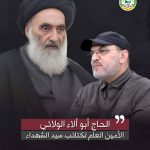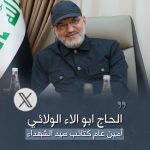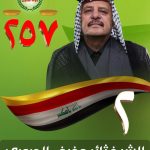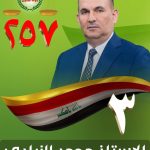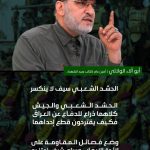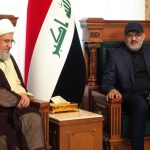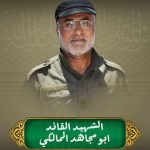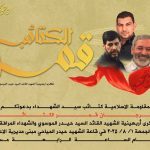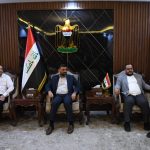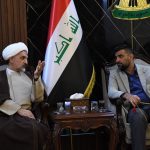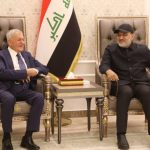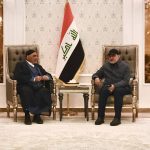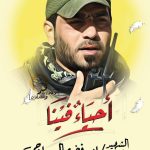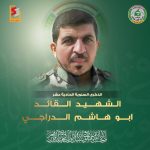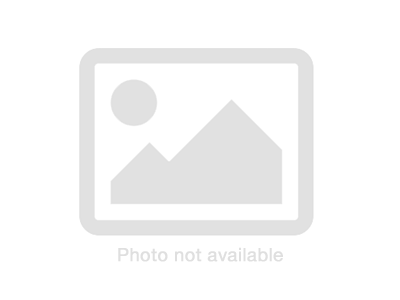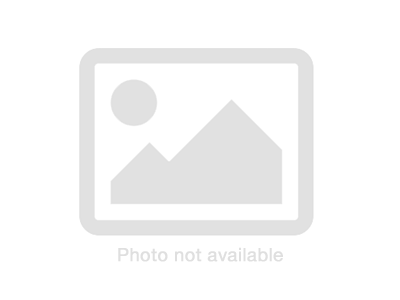![نظرية الجهاد عند الإمام الخميني قراءة وتأملات [02]](https://saidshuhada.com/files/1_496319797.jpg)
الحقيقة كان يمكن لهذه النقطة أن تندرج في النقاط السالفة، لولا أن الهدف هو إبراز محورية أمريكا دولياً و«إسرائيل» إقليمياً في المواجهة الحاضرة التي يعيشها المسلمون.
النص الخمينيّ حافل بدلالات مكثفة على مواجهة الاستكبار بصرف النظر عن هويته، سواء أكان غربياً أو شرقياً، رأسمالياً أو شيوعياً، إذ المطلوب مواجهة كل ضروب التبعية والقطع معها: «دافعوا حيثما كنتم عن إسلامكم ووطنكم، وقاوموا عدوكم المتمثل بأمريكا والصهيونية العالمية والقوى الكبرى الشرقية والغربية» [1]. كذلك تساؤله أمام مجموعة من الضبّاط الباكستانيين الذين زاروا سماحته في شهر محرم 1400هـ: «إلى متى نبقى تحت سلطة الأجانب؟ إلى متى يحكمنا المستشارون العسكريون الروس والأمريكيون؟ وإلى متى يحكمنا عريف روسي أو أمريكي أو بريطاني؟» [2]. وربما كان أوضح من ذلك كله كلام الإمام ربيع عام 1980م: «إننا نعادي الشيوعية العالمية بقدر مناهضتنا القوية للمستعمرين الغربيين بزعامة أمريكا والصهيونية وإسرائيل. أصدقائي الأعزاء: اعلموا أن خطر الشيوعية ليس بأقل من خطر أمريكا… لأن كلتا القوتين المتجبرتين متأهبتان للقضاء على الشعوب المستضعفة» [3].
بيد أن ذلك كله لا يمنع من قراءة الواقع وإعادة ترتيب الأولويات بدقة لرؤية الأخطار التي تحدق ببلاد المسلمين. ولا ريب أن قراءة كهذه تفيد أن أمريكا هي الخطر الأول الذي راح يواجه العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإلى جوارها ركيزتها «إسرائيل» ، خاصة مع وجود الحصانة النفسية والوجدانية التي تتحلى بها الشعوب بإزاء المذهبية الماركسية ونظامها السياسي والاجتماعي ورؤيتها الثقافية والاقتصادية.
أما في ظل التطورات الحاضرة التي تسارعت في منطقتنا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيّات القرن الماضي، فلم يعد الخطر الأمريكي-الصهيوني موضع شك أو تردد من أحد.
على هذا، من المنطقي أن يكون الخطاب النهضوي الخمينيّ منسجماً مع نفسه، حين يحذّر من مركزية التهديد الأمريكي وخصوصيته لإيران والعالم الإسلامي، دون أن يهمل مخفرها الأمامي في منطقتنا (إسرائيل): «ألا فليعلم العالم بأسره أن جميع مصائب شعب إيران وبقية الشعوب الإسلامية إنما مصدرها الأجانب المستعمرون خاصة الأمريكان» [4].
كذلك وعلى نحو دال، تصريحات سماحته:
«إن كل مصائبنا اليوم هي من أمريكا وإسرائيل، فإسرائيل جزء من أمريكا» [5].
«بالأمس كانت البلاد الإسلامية عامة تئن من وطأة الاستعمار الإنجليزي وحكم أذنابهم، واليوم تئن من قبضة الأمريكان الاستعمارية وعملائهم المحليين» [6].
«أمريكا هي التي تتعامل مع المسلمين بهذا الشكل الهمجي…أمريكا هي التي تعد الإسلام عدواً وخصماً لها» [7].
مع أن الفكر الخمينيّ يدخل في قطيعة شاملة مع التبعيات مهما كان لونها ومرجعها الدولي، لكن ذلك لم يمنع أن تكون وجهة النهضة و«وجهة الشعب الإيراني المسلم ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية والقضاء عليها» [8].
«لقد أصبحت بلادنا سوقاً لأمريكا» [9].
يحرص الإمام في الأغلب على الجمع في نصوصه بين الخطر الأمريكي والخطر الصهيوني، انسجاماً مع فهمه الذي يرى فيه «إسرائيل» جزءاً من أمريكا نفسها، حتى لنستطيع القول باطمئنان إن العالم الإسلامي لم يشهد في العقود الأخيرة رائداً من رواد النهضة ورموز الإحياء أولى الخطر الأمريكي والإسرائيلي كل هذا الاهتمام.
فيما تبقى من مساحة هذه الفقرة، نمر على عدد من النصوص الدالة تاركين التفاصيل إلى الملفات المختصة التي غطّت هذا الجانب من فكر الإمام[10]:
{يذهب الإمام إلى أن المشروع الاحتلالي الاستيطاني الصهيوني ولد نتيجة حالة توافق استراتيجي دولي بين الشرق والغرب. فقوى الغرب والشرق على تنافسها في ما بينها هي متفقة في أطماعها بالعالم الإسلامي، لذلك لم يكن غريباً أن تلجأ إلى زرع ما دأب الفكر السياسي للإمام على تسميته بـ«الغدة السرطانية» ، حيث يقول: «لقد كانت ولادة إسرائيل نتيجة طبيعية للتوافق الفكري بين دول الاستعمار الشرقية والغربية. حيث عملوا بإيجادها على استغلال العالم الإسلامي واستعماره واقتسامه وتدميره، واليوم نرى بوضوح دعم كل الأطراف الاستعمارية لها» [11].
{عندما انطلقت حرب رمضان عام 1393هـ (1973م) عبّر الإمام عن تأييده لها بحماس منقطع النظير، إذ لم نلمس لعلماء المسلمين على كثرتهم مثل اهتمامه بموضوعها: «الآن وقد اشتعلت نار الحرب مرة أخرى، وهبّ المسلمون من إخواننا يضحّون بأنفسهم في ساحات القتال وميادين الشرف ببطولة نادرة ومشرّفة من أجل استئصال جذور الفساد ومن أجل تحرير فلسطين، فإن واجب جميع الدول الإسلامية ـ وخاصة الحكومات العربية، وبعد الاتكال على الله وقدرته الأزلية ـ هو تعبئة جميع طاقاتها وقواها والمبادرة إلى مساعدة الرجال المضحّين على خط النار، فهم متطلعون إلى أمّتهم الإسلامية بكل أمل، وأن تشترك في تحرير فلسطين وبعث كرامة الأمة وعظمة الإسلام في هذا الجهاد المقدس» [12].
عن زيارة السادات للقدس عام 1977م ومرحلة كامب ديفيد، قال سماحته: «اتفاقية كامب ديفيد ليست إلا خدعة ولعبة سياسية لمواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسلمين، وإنني قد أدنت إسرائيل في كلماتي وبياناتي منذ أكثر من (15) سنة، ودافعت عن الشعب الفلسطيني وأراضيه» [13].
عندما احتلَّت قوات العدو الصهيوني الجنوب اللبناني في ربيع 1978م أدان الإمام تحالف النظام الملكي في إيران مع تل أبيب ودعمه لها، ثم قال محذراً: «أكثر حكومات البلدان الإسلامية تقف متفرجة أمام هذا الأمر المصيري، غافلة عن أنها لو استمرت في تقدمها هذا فستعامل الدول الأخرى بنفس الأسلوب» [14].
«منذ ما يقارب العشرين سنة أعلنت في كلماتي والبيانات الصادرة عنّي عن مخالفتي لعلاقة الشاه بإسرائيل، كما أعلنت عن دعمنا ونصرتنا لقضايا الأمة العربية والفلسطينية المشروعة الحقة ولثورتهم ضدّ إسرائيل» [15].
«منذ سنوات طويلة كنت قد تحدثت مراراً عن إسرائيل وجرائمها وقلت إنها غدة سرطانية زرعت في زاوية من زوايا العالم الإسلامي، وهي لا تكتفي بالقدس بل تريد التوسع أكثر، وسياستها تابعة للسياسة الأمريكية» [16].
بتاريخ 10/11/1979 التقى مراسل تلفزيون ألمانيا الغربية بالإمام الخمينيّ وسأله: «من مطالبكم القضاء على إسرائيل، فما هو مصير اليهود فيما لو انتصر الشعب الفلسطيني وقضي على إسرائيل؟ فأجاب سماحته: «إن حساب اليهود منفصل عن حساب الصهاينة، فإذا ما انتصر المسلمون على الصهاينة، فسيكون مصير اليهود كمصير اليهود عندنا بعد القضاء على الشاه المخلوع. فلا شأن لنا باليهود، إنهم أمة كسائر الأمم الأخرى ولهم حقّ في الحياة» [17].
أما الحل فلا يخفي الإمام أنه يمثل بالقضاء على «إسرائيل» ككيان سياسي احتلالي، وإلا فما لم «تجتث الأمة الإسلامية جرثومة الفساد هذه من الجذور، فلن يهدأ لها بال ولن يستقر فيها حال» [18].
6-المسألة الثقافية
لكي نتوفر على رؤية مباشرة وواضحة في نظرة الإمام الخمينيّ للثقافة، سنتحاشى الدخول في جدل المعنى واختلاف التعريف[19]، ونعتمد على المعنى العرفي المتداول على مستوى الوعي العام.
كما يمكن لمحصلة النقاط التي سنعرض لها لاحقاً أن ترسم لنا تحديداً للثقافة التي يتحدث عنها الإمام. وبرغم اعترافنا بتعقيد جوانب المسألة الثقافية عندما نريد أن نطل عليها من فكر النهضة على وجه التحديد، إلاّ أن ذلك لا يمنعنا من متابعة أساسيات تعريف الإمام للمسألة الثقافية من منظور الثورة التي انطلقت في إيران، أو النهضة التي يراد لها أن تتحرك في العالم الإسلامي.
ومع كثافة هذه الأساسيات وامتدادها سنركز على أربعة منها، ربما لأنها عناصر مشتركة أو هموم موحدة تشغل الوعي الإسلامي التغييري على امتداد رقعة العالم الإسلامي من مغربه حتى مشرقه.
وهذه الأساسيات التي نعنيها، هي:
1- الثقافة كأصل.
2- هوية الثقافة.
3- الأصالة ونفي التغريب.
4- البعد المعنوي في الثقافة.
الثقافة كأصل
تفيد نصوص الخطاب النهضوي للإمام بمركزية الثقافة في النهضة بشكل عام وفي حركة الثورة بشكل خاص. لذلك نجد أن الميراث الذي تركه الإمام تحتل فيه الثقافة حيزاً كبيراً.
عندما نسجل أن الثقافة تحتل موقعاً مركزياً في النهضة، فإن ما نعنيه هو توفر رؤية الإمام على عناصر تحليل ومخاطبة لا تقتصر على أوضاع إيران الثقافية، بل تمتد لتشمل أوضاع العالم الإسلامي بشكل خاص، والشعوب المستضعفة بشكل عام. إن المقولات التي أطلقها الإمام بشأن مركزية الثقافة، الاستقلال الثقافي، التبعية الثقافية، الهوية الثقافية، هي مقولات يتجاوز مداها الشأن الإيراني والإسلامي لتعمّ شعوب الأرض جميعاً من دون استثناء، بصرف النظر عن طبيعة الموقف الفكري الأيديولوجي والعملي منها.
ما يمكن أن نلمسه في نصوص الإمام ورؤاه ومواقفه الثقافية هو هذه السعة والامتداد والعراقة، حيث اقترن انشغاله بالمسألة الثقافية مع بواكير حياته العامة، إذ كتب «كشف الأسرار» في العقد الثالث من حياته. وهذا الكتاب علاوة على أنه ردّ نقضي على صاحب كتاب «أسرار عمرها ألف عام» ، فهو ينطوي على رؤى نافذة في المسألة الثقافية، بيد أن الذي يؤسف له، أنه لم ينل حتى اللحظة العناية الكافية التي يستحقها.
الثقافة إذن أصل. وعندما نعود للنصوص الدالة نقرأ على لسان الإمام بعد مدة وجيزة جداً من الانتصار وتحديداً في 9/7/1933هـ قول سماحته: «الثقافة على رأس الأمور كلها» . هذا الأصل يقرره الإمام بدايات الانتصار ليتحول إلى أساس في بناء الدولة الإسلامية.
لكي يدلل سماحته على أولوية المسألة الثقافية في الثورة -داخل إيران- يلفت نظر المسؤولين إلى هذا الواقع بقوله: «إن ثقافتنا ومدارسنا كانت منذ أول يوم مورد اهتمام المخالفين لأنهم يعلمون أن كل ما يحدث هو بسبب الثقافة» .
أما على مستوى خطاب النهضة العام الذي يتجاوز إقليم الثورة ويشمل العالم الإسلامي فالإمام يقرر مسألة على غاية الخطورة في قضية الثقافة حين يقول: «إن طريق إصلاح بلد ما يمر من إصلاح ثقافته. ولابدّ أن يبدأ الإصلاح من الثقافة» .
يعود تاريخ هذا النص إلى ما يزيد على الثلاثة عقود من الآن وبالتحديد لتاريخ 1/5/1384هـ. ولهذا دلالته على صعيد الإشارة إلى عنصر الثقافة وموقعها المبكر في الحركة الإحيائية للإمام.
أن الثقافة حين ترتقي لتكون أصلاً فهي تتجاوز في محتواها المعلومات المجردة والمعارف المحضة وحتى حصيلة الوعي الاجتماعي إلى ما يقاربها بمعنى الحضارة. وإذا صحّت هذه المقاربة فهي تعيد إلى الأذهان إلى ما كان يلحّ عليه المرحوم مالك بن نبي في عظيم تأكيده على الحضارة وهو يصيح: «إن مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة حضارية» .
أما الإمام فيرى أن المشكلة هي مشكلة الثقافة و «أن كل ما يحدث هو بسبب الثقافة» و «طريق إصلاح أي بلد يمر عبر إصلاح ثقافته» لذلك «لابدّ أن يبدأ الإصلاح من الثقافة» .
لكن ينبغي لهذه الرؤية أن لا تصنّم الثقافة من جهة، كما عليها من الجهة الثانية أن لا تسقط في المثالية النظرية بإلغائها الواقع وتسطيحها لعوامل التعويق الخطيرة التي يكتنزها.
ثمَّ ملاحظة أخرى فعندما نشير إلى أن الثقافة أصل في حركة الإحياء الديني التي قادها الإمام، فلا نعني بذلك ما يساوي الاستخدام الحديث للعقل -مثلاً- كأصل. وإنما تقوم الثقافة بوظيفة إجرائية، ولكن أيضاً لا بالمعنى الفني لكلمة إجرائي ووظيفي. فهي أقل من الأصل القائم بذاته المنفصل عن غيره المهيمن على ما سواه، وبالتالي فهي ليست سلطة ولا مرجعاً سلطوياً قامعاً ومهيمناً، كما لا تختزل أيضاً بكونها مجرد أداة إجرائية لا تعي لنفسها وظيفة إلا في سياق السلطة التي تحركها، إنما هي حد وسط بين الأصل القامع والوجود التابع.
هوية الثقافة ومرتكزها
الثقافة مصطلح عام والجدل ما يزال يشغل العالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع حول المسألة الثقافية من زاوية ما تكون عليه من تنوّع وخصوصية، فثمة من يذهب إلى أن الثقافة الإنسانية واحدة لا تتجزأ وهي تعمّ البشر جميعاً، فيما يذهب البعض الآخر إلى خصوصية ثقافة كل مجتمع وفئة وأمة. هناك في العالم العربي والإسلامي من يتبنى الحالة المنطلقة من مفهوم «المثاقفة» الذي يعني به الاحتفاظ بالخصوصية والانفتاح على ثقافة الآخرين.
وعندما نعود بالمسألة إلى رؤية الإمام نلاحظ أنه يعيد بناءها عبر جدل معين وعلاقة تنتظم مجموعة عناصر تجمعها إلى بعضها لصياغة الرؤية الأخيرة. الإنسان لدى الإمام هو أساس الهزيمة والنصر، وعلى حدّ قول سماحته: «جميع الانتصارات والهزائم تنطلق من الإنسان» .
لكن من يبني الإنسان ويصوغه؟ يجيب الإمام: «الثقافة مصنع الإنسان» . هذا المعنى لدور الثقافة يتقارب بل يتطابق مع المعنى الكانتي للثقافة ودورها وعلاقتها بالإنسان، إذ يقول كانت (ت: 1804): «إن كل التقدم الثقافي يمثل تعليم الإنسان… وأكثر الموضوعات أهمية بالنسبة للثقافة هو الإنسان الذي وُهب العقل» [20].
إذا توفر الإنسان أمكن للنهضة أن تنطلق. وبحسب نصوص الإمام: «إذا صنعنا الإنسان فإن وطننا ينمو ويتكامل» ، وفي نص آخر يقول: «إن مصير البلاد بيد الإنسان» وإذ يتضح دور الثقافة والإنسان الذي تبنيه، فإن السؤال الأساس يبقى معلقاً على معرفة ماهية هذه الثقافة والمرتكز الذي تقوم عليه.
عند هذه النقطة يواجهنا النص الخمينيّ التالي: «المدارس الإلهية والتوحيدية هي التي تصنع الإنسان [و] إذا وجد الإنسان في بلد فأنه يجلب له الحرية والاستقلال الفكري والاستقلال الروحي والاستقلال الإنساني» .
إذن، فالتوحيد هو مرتكز الثقافة المنشودة وماهيتها، والإسلام هويتها، على هذا المنوال نؤسس خصوصيتنا في مسألة الثقافة عندما نطرح موضوع الثقافة الإسلامية كمصنع لإعداد وبناء الإنسان القادر على إيجاد النهضة.
بيد أن المشكلة أن الإمام في صدد نهضة، والنهضة موضوع منوّع، من جدلية البناء والهدم والمواجهة والتحدي، لذلك فإن مجرد تقرير هوية ومرتكز وماهية للثقافة لا يعني غلق المسألة وحسم الموضوع، لا سيما أن ّالعالم الإسلامي مستباح بجلّه للغرب منهك بالاستبداد الداخلي، بعبارة أوضح: إن طرح مقولة خصوصية الثقافة الإسلامية كأصل من أصول النهضة والإحياء في إيران والعالم الإسلامي لا ينهي المشكلة، ففي العالم الإسلامي الآن أنظمة تعمل ضد الثقافة الإسلامية، والشعوب الإسلامية تعيش ارتهانات وتبعيات موغلة للغرب، منها التبعية الثقافية، فكيف يصار إذن إلى تعميم الثقافة الإسلامية بمواجهة ثقافة التغريب؟
ثمَّّّّّ إن الثقافة الإسلامية ذاتها عنوان عام يحتمل ـ بل يطوي ـ الكثير من الاحتمالات والتأويلات التي تجعلها صيغاً وأنماطاً متضاربة أحياناً، لذلك سينبثق سؤال عن خصائص الثقافة القادرة على بناء الإنسان وصياغته وانطلاق النهضة.
منهج الإمام أثناء تعاطيه مع الهم الثقافي في الكثير من النقاط التفصيلية التي توفر إجابة عن الأسئلة الآنفة وغيرها، ولما كان المكان لا يتيح أكثر من استعراض الأساسيات، فسنتابع اثنين من أخطر التحديات التي تثار بوجه الثقافة الإسلامية، وبالتحديد ثقافة النهضة والتغيير.
الأصالة ونفي التغريب
يحتفظ النص النهضوي والإحيائي للإمام بقيمة حيوية في معالجة قضايا التغريب في الثقافة الإسلامية وواقع المسلمين. ولعل أحد أبرز أسباب هذه الحيوية تكمن في أن نهضة الإمام انطلقت في ظرف تعيش فيه الأمة استلاباً خطيراً إزاء الغرب، وفي وقت بلغت فيه سطوة الغرب ذروتها على العالم الإسلامي.
الأصالة الإسلامية ونفي التغريب حقيقة شديدة الحضور في فكر الإمام ونهضته. يقول سماحته مخاطباً المسلمين في نداء الحج لموسم سنة 1400هـ: «اعتمدوا على الفكر الإسلامي وحاربوا الغرب والتغرب وقفوا على أقدامكم واحملوا على المثقفين الموالين للغرب الشرق واكشفوا هويتهم» . هذا النص للإمام هو نص نهضة عبر ما ينطوي عليه من شمولية وعموم للمسلمين كافة. كما أنه يحمل الدلالتين معاً، دلالة استعادة الهوية واكتشافها من خلال الأصالة، ونفي التغريب.
هذا النص ينصب الهوية أصلاً إزاء تيارات الغرب والشرق ومنهجياتهما، لاسيما أن العادة جرت على استخدام مصطلح التغريب كعنوان دال على كافة المؤثرات التي تتموضع في بنية الثقافة الإسلامية ومضمونها من الشرق والغرب معاً. عندما تتحول الثقافة إلى سلطة تقمع وتلغي وجود الثقافات الأخرى أو على الأقل تشوهها وتهمشها، مستفيدة من ألوف المعارف البشرية والأرضية شرقية وغربية، ستكون عندئذٍ أُمّ الأمراض أو بتعبير الإمام في وصفها: «إن الثقافة الاستعمارية التي تزداد يومياً هي أُمّ الأمراض» ، بل يذهب الإمام إلى أن سقوط العالم الإسلامي بدأ أولاً من خلال التسلط الثقافي الغربي وإن أكبر التبعيات التي تسود الشعوب الإسلامية والمستضعفة هي التبعية الفكرية.
في نصين متوازيين يعبر الخطاب الخمينيّ عن هذه الحقيقة بقوله: «إن أكبر التبعيات هي تبعية الشعوب المستضعفة الفكرية للقوى الكبرى وللمستكبرين. وجميع التبعيات تنبع من التبعية الفكرية هذه، ومادام الشعب لم يحصل على الاستقلال الفكري فلا يمكنه أن يستقلّ في الأبعاد الأخرى» . وفي النص الثاني يقول سماحته مخاطباً وفداً من لبنان زاره سنة 1400هـ: «إن السبب الأساس في تسلط الغرب أو الشرق على جميع الأقطار الإسلامية هو التسلط الثقافي» .
الحقيقة أن هذا الفهم لم يعد غريباً حتى في تيارات الفكر العربي المعاصر المهموم بقضايا تغيير الأمة، فهذا أحد رموز هذا الفكر يكتب نصاً: «فقد كان من أهداف الاستعمار القضاء على الهويّات الثقافية للشعوب كمقدمة للقضاء على الهويات القومية حتى يسهل عليه السيطرة العسكرية والهيمنة الثقافية. وكانت حجة الاستعمار في الاستمرار أنه لا توجد هويات قومية أو ثقافية للمستعمرات! وما زال الغزو الثقافي مستمراً بالرغم من تغير أشكاله بما في ذلك نقل التكنولوجيا» [21].
شارك المقال